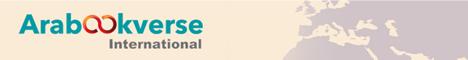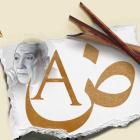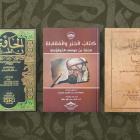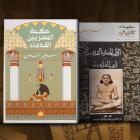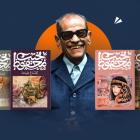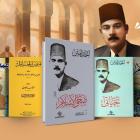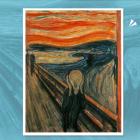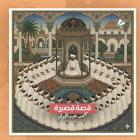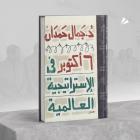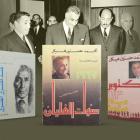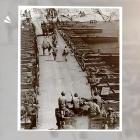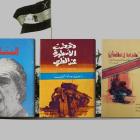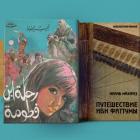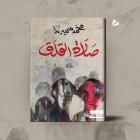معرفة
التاريخ لا يكتبه المنتصرون: عن السرديات المختلفة لتاريخ صدر الإسلام
من الشيعة إلى الخوارج فالمعتزلة: هل يمكن أن يروي كل مذهب تاريخًا مختلفًا؟ روايات قد تُغيِّر نظرتك إلى صدر الإسلام.
 أغلفة كتب: «شرح نهج البلاغة»، «الكشف والبيان»، «العثمانية»، و«عيون الأخبار وفنون الآثار»
أغلفة كتب: «شرح نهج البلاغة»، «الكشف والبيان»، «العثمانية»، و«عيون الأخبار وفنون الآثار»
على الرغم من خطئها ومجافاتها لمنهج البحث التاريخي، تَلْقى مقولة «التاريخ يكتبه المنتصرون» رواجًا واسعًا، ويتعامل معها البعض كأنها الجملة السحرية الكفيلة بإسقاط أي وجهة نظر تاريخية لا تروقه.
عند التأمل في التاريخ الإسلامي نجد ما يمكن أن نسميه هيمنة المذهب السني في حواضر الشرق الإسلامي، باستثناء فترة الدولة الفاطمية، ومع حضور المذهب السني وطبقًا لتلك المقولة التي ذكرتها في البداية كان يجب ألّا نجد أي روايات تخالف السردية التاريخية السنية، إلا أن الواقع خلاف ذلك؛ فوصلت إلينا المصادر الشيعية بشقيها الإمامي والإسماعيلي، وكذلك المصادر الإباضية والمعتزلية، فأصبح لدينا وجهات نظر تاريخية تعبر عن مختلف المذاهب والفرق الإسلامية.
وفيما يلي إشارة لأبرز تلك السرديات وبعض مصادرها الهامة، مع الإشارة لسياقات نشأة الفرق:
الشيعة وحق الخلافة المسلوب
تتضارب الآراء بشأن توقيت نشأة التشيع المبكر، لكن ثمة تصور يعود بجذور التشيع كفكر سياسي لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية بعض الصحابة أن الخلافة من حق الإمام علي بن أبي طالب. ثم يظهر مصطلح "شيعة علي" في المصادر التاريخية إبان أحداث الفتنة الكبرى. لكن على أي حال فقد اعترف الإمام بخلافة سابقيه، وبرز دوره كمستشار في عهد الفاروق وشطر خلافة ذي النورين. وفي خلافته برز مصطلح الشيعة كحزب سياسي يضم مؤيديه ثم أتباع ذريته من بعده.
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين:
الأول: أن ظهور التشيع العقدي جاء في مراحل لاحقة عن التشيع السياسي.
والأمر الثاني: أنه وفقًا للسردية الشيعية فقد ظهر مفهوم الإمامة الذي قصر الخلافة الشرعية في الإمام وذريته، وما ترتب عليه من ظهور نظرية عصمة الأئمة الاثني عشر: الإمام وابنيه، ثم علي زين العابدين بن الحسين وأبنائه من بعده، بداية من الإمام الباقر وانتهاء بالمهدي المنتظر ابن الحسن العسكري.
ويجب الانتباه له أنه بوفاة إسماعيل بن جعفر الصادق قبل أبيه وجد العقل الشيعي نفسه أمام سؤال: هل يجوز انتقال الإمامة من الأخ إلى أخيه؟ أم أن ذلك يقتصر على الحسن والحسين؟ وبغض النظر عن التنظيرات الشيعية لتلك المسألة فقد ظهر الانقسام الشيعي الأبرز؛ تيار أجاز انتقال الإمامة بين الإخوة لتنتقل الإمامة إلى موسى الكاظم وذريته ليظهر التشيع الاثنا عشري، وظهر تيار آخر لم يقبل بانتقال الإمامة فكان الأئمة عنده إسماعيل بن جعفر ثم ابنه محمد بن إسماعيل، ليظهر تيار الشيعة الإسماعيلية التي جعلت الأئمة يدخلون في دور الستر الذي انتهى بظهور الدولة الفاطمية.
وطبيعي أن يكون لهاتين الفرقتين مصادر تاريخية عدة تتناول تاريخهما، ولكن لا تسمح مساحة هذا المقال بحصر المصنفات التاريخية الشيعية أو غيرها بشكل كامل.
سليم بن قيس الهلالي
سليم بن قيس الهلالي تُوفي في حدود ٩٥ هـ، دخل المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وكان من أصحاب الإمام علي وأبنائه، ولا يُعرف له أثر أو ترجمة واسعة سوى كتاب «سليم بن قيس» المنسوب إليه.
والكتاب نفسه يثير الجدل بين علماء الشيعة بمختلف طبقاتهم؛ فهناك من يرفض وجوده أصلًا، وهناك من يرى أن ما وصل إلينا هو كتاب محرّف لا علاقة لسليم بن قيس به. ويرى المؤرخ الشيعي المعاصر صائب عبد الحميد أن الكتاب يتضمن أخبارًا لا تصمد أمام النقد التاريخي.
وفيما يتعلق بكتاب سليم بن قيس الهلالي فهو يُعرَف بعدة أسماء، منها: «أسرار آل محمد»، «كتاب سليم»، «أبجد الشيعة»، «كتاب السقيفة»، وغير ذلك. وينقسم الكتاب إلى جزء تاريخي في البداية يتناول ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، ويسوق الأحداث من وجهة نظر شيعية بطبيعة الحال، ثم يتطرق لبعض المرويات عن الإمام علي وذريته كالإمامين الصادق والباقر.
لا تبدو الروايات في كتاب سليم مرتبة تاريخيًا باستثناء وفاة النبي والسقيفة، لكنها تتعلق كلها بفترة صدر الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرًا مما ورد في هذا الكتاب موضع خلاف بين علماء الشيعة أنفسهم، كواقعة حرق دار السيدة فاطمة الزهراء ومقتلها.
وللكتاب عدة طبعات عربية وفارسية، لكن أوسعها وأكثرها شمولية من حيث إيراد الإشكالات حول الكتاب والاستدراكات من النسخ المخطوطة هي طبعة المحقق الشيعي محمد باقر الزنجاني، وهي طبعة ضخمة شَغَل المتنُ الفعلي للكتاب فيها حوالي الربع أو أقل. وبديهي أننا نتحدث عن طبعة شاملة لا دقيقة، لاسيما والكتاب نفسه، أو للدقة متن الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، هو ما يعتريه الشك.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
لا تتوافر معلومات كثيرة عنه، سوى أنه كان من أهل القرن الخامس الهجري ومن أساتذة العالم الشيعي المشهور ابن شهر آشوب صاحب كتاب «مناقب آل أبي طالب». لم يؤلف الطبرسي «الاحتجاج» بقصد التأريخ لفترة صدر الإسلام، وإنما كتبه لأنه وجد أقرانه من رجال وعلماء الشيعة يعرضون عن الاحتجاجات والجدال على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الاثنا عشر لم يجادلوا أحدًا؛ وهو ما رفضه المؤلف وأدى به إلى تأليف الكتاب.
معظم الكتاب يمثل احتجاجات أو اعتراضات أو ردود الإمام علي وبنوه على مخالفيهم، وغالبها تندرج فيه أخبار تاريخية لفترة صدر الإسلام من وجهة النظر الشيعية؛ فالسرد التاريخي هو المكون الأبرز في الكتاب. وأفضل طبعات الكتاب وأكثرها انتشارًا هي طبعة مؤسسة الشريف الرضي، والتي جاءت في مجلدين.
الداعي عماد الدين إدريس
كان من دعاة الإسماعيلية المتأخرين في اليمن، وتولى أمور الدعوة بوصفه الداعي المطلق، وهو منصب إسماعيلي هام. وُلِد في أواخر القرن الثامن الهجري، وتوفي في الثلث الأخير من القرن التاسع الهجري سنة ٨٧٢ هـ. وأثناء حياته عمل على نشر الدعوة الإسماعيلية في الهند واليمن.
وعلى الرغم من تأخره الزمني فإنه أهم مؤرخي الدعوة الإسماعيلية؛ فقد اطّلع على تراث ومخطوطات لم تصلنا. ووصلت إلينا بعض مؤلفاته، ويهمنا منها «عيون الأخبار وفنون الآثار في ذكر النبي والوصي والأئمة»، المعروف اختصارًا بـ «عيون الأخبار وفنون الآثار».
جاء «عيون الأخبار» في سبعة أجزاء أو أسباع، وما يهمنا هو الأجزاء الثلاثة الأولى: السبع الأول، والثاني، والثالث؛ وتلك الأجزاء تغطي فترة صدر الإسلام. وتأتي فكرة تقسيم الكتاب إلى سبعة أجزاء من أهمية الرقم سبعة عند الشيعة الإسماعيلية.
الكتاب يمثل وجهة نظر الإسماعيلية في التاريخ الإسلامي، فالمؤلف يقدم رؤيته الكاملة للتاريخ حتى عصره، وتغطي هذه الرؤية فترة طويلة تمتد لما بعد نهاية الدولة الفاطمية في مصر.
وإن كانت رؤيته لتاريخ صدر الإسلام تتشابه مع السردية الشيعية المعتادة، إلا أن القارئ سوف يشعر بشيء من الاختلاف على مستوى الأسلوب والألفاظ. وأفضل طبعات الكتاب هي الطبعة الصادرة عن معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن، والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، وحقق الأجزاء الأولى أحمد شيلات ومأمون صغرجي.
الإباضية: عندما يقرأ المذهب العقدي حركة التاريخ
معروفة هي قصة التحكيم بين علي ومعاوية وظهور الخوارج الذين رفضوا التحكيم باعتباره كفرًا، لتتطور الأحداث حتى تؤدي إلى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وظهور الخوارج كفرقة عقدية مستقلة، انقسمت بدورها إلى فرق أخرى، من ضمنها الإباضية.
يعرف تاريخ الفرق وعلم المقالات الجدال المصاحب لنشأة الإباضية، وهل يصح اعتبارها من الخوارج؟ لاسيما وقد تخلّوا عن الكثير من المواقف المتطرفة للخوارج، وأبرزها التكفير، ليحل محله فكرة البراءة من مخالفيهم، وعلى رأسهم الإمام علي بعد قبوله التحكيم، وذي النورين عثمان بن عفان في النصف الثاني من خلافته.
لكن القدر التاريخي المتفق عليه، حتى بين مؤرخي الإباضية أنفسهم، أن المذهب الإباضي تعود جذوره إلى شخصين هما: جابر بن زيد، وعبد الله بن إباض. وقد مر المذهب الإباضي بأطوار فكرية وسياسية عدة حتى يومنا هذا، وأصبح المذهب الإباضي هو المذهب الرسمي لسلطنة عمان، وكان لهم هم الآخرون سرديتهم التاريخية الخاصة.
عبد الله بن إباض
عبد الله بن إباض أحد المنظِّرين الأوائل للفكر الإباضي. وعلى الرغم من إشارة المؤرخين لجابر بن زيد بوصفه المنظِّر الأساسي للفكر الإباضي، إلا أن النسبة لاسم عبد الله بن إباض قد شاعت في نهاية القرن الثالث الهجري.
لم تُتح معلومات كثيرة عن حياته الخاصة، لكنه عُرف بالصلاح والتقوى، وأدرك الكثير من الصحابة؛ فهو من التابعين، واشتهر بدفاعه عن آرائه. وترك لنا رسالته للخليفة عبد الملك بن مروان، التي تمثل وجهة نظر قريبة جدًا من تلك الفترة؛ فقد تُوفي عبد الله بن إباض سنة ٨٦ هـ، وشبَّ في عهد معاوية بن أبي سفيان، فهو قريب العهد بما حدث.
في تلك الرسالة يبدو الموقف الإباضي القديم من الخلفاء الأربعة؛ فهم راضون تمام الرضا عن فترة خلافة الشيخين: أبي بكر وعمر، وشطر من خلافة عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك ينتقدون سيرة عثمان ومعاوية. ويبدو ابن إباض مبغضًا لمعاوية الذي عاصره وأدرك فترة حكمه وسياساته. وفي الوقت نفسه يفرق ابن إباض بين المبدأ الديني والواقع؛ فلا يعتبر الانتصار علامة على أن المنتصر هو صاحب الحق.
وبالنسبة لنص الرسالة الكاملة فهي موجودة في المصادر الإباضية القديمة والمعاصرة، مثل كتاب «إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء». وقد نُشرت محقَّقة في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية سنة ٢٠٢٠م.
ابن سلام الإباضي
المعلومات المتعلقة بابن سلام الإباضي قليلة جدًا، وكل ما أمكن الوصول إليه من معلومات حوله مستنتج من كتابه نفسه ومن مؤلِّف إباضي آخر هو الشماخي. لكن على كل حال فالواضح أن ابن سلام عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ووفقًا لتقديرات بعض الباحثين يعد كتاب ابن سلام أقدم كتاب وصلنا من مصادر تاريخ المغرب.
يمثل الكتاب وجهة نظر إباضية في تاريخ صدر الإسلام، وهو مقسَّم كالتالي: مقدمة عقدية وفقًا للمذهب الإباضي، ثم حديث عن فضائل بعض الصحابة، ويحاول المؤلف التركيز على أن أفكار الإباضية مستمدة من آراء الصحابة، وهو أمر تحرص عليه كل الفرق بوجه عام.
ثم يتحدث عن الولاء والبراء، وهو مبدأ هام يمثل أحد المعالم الرئيسية في الفكر الإباضي، ثم يتناول بعض المسائل العقدية والفقهية، ثم يتحدث عن الفتنة الكبرى وأمر عثمان وعلي وموقف الإباضية منهم، ثم يتحدث بعد ذلك عن تاريخ الإباضية في المغرب.
وقد نُشر الكتاب بتحقيق فيرز شفارتس والشيخ سالم بن يعقوب، عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ضمن سلسلة النشرات الإسلامية.
أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي
بخلت علينا المصادر بمعلومات دقيقة عنه إلى درجة الخلاف في الفترة التي عاش فيها؛ فيجعله البعض من أهل القرن السادس الهجري، كما في «معجم أعلام الإباضية»، بينما ترى الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف أنه من أهل القرن الرابع الهجري، وما ذكرته الدكتورة سيدة في مقدمة تحقيقها لكتاب «الكشف والبيان» هو الأصح وفقًا لسياق الكتاب نفسه.
وقد ترك الرجل مؤلفات عدة، ما يهمنا منها هو كتاب «الكشف والبيان». بالنسبة لكتاب «الكشف والبيان» فهو كتاب في العقيدة والتاريخ من منظور إباضي.
ويهمنا منه الجزء الثاني، فقد جاء في قصص الأنبياء والسيرة النبوية، ثم الخلفاء الأربعة، وينتهي بفترة حكم عبد الملك بن مروان. ثم يتخذ من حديث الفرقة الناجية مدخلًا للحديث عن الفرق الإسلامية من منظور إباضي، ويذكر طرفًا من أخبار الحياة الدينية للعرب قبل الإسلام، ويتحدث بإيجاز عن مذاهب وديانات غير المسلمين.
والطبعة المتداولة هي طبعة وزارة الثقافة والتراث القومي في سلطنة عمان، بتحقيق الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف، والتي صدرت سنة ١٩٨٠م، وثمة طبعة أحدث نُشرت في لندن منذ سنوات.
المعتزلة: رؤية عقلانية لتاريخ صدر الإسلام
لعل أشهر الآراء حول نشأة المعتزلة هو ما يُعزى نشأتها لواصل بن عطاء الذي اختلف مع الحسن البصري حول مرتكب الكبيرة، فاعتزل واصل مجلسه بسبب هذا الخلاف، فقال الحسن جملته الشهيرة: اعتزلنا واصل.
وثمة رأي آخر يعود بجذور الفكر الاعتزالي للصحابة الذين اعتزلوا الفريقين المتنازعين في أحداث الفتنة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة سعد بن أبي وقاص. ويميل بعض المعتزلة مثل ابن أبي الحديد لرأي يعود بجذور الاعتزال إلى أفكار الإمام علي بن أبي طالب.
لكن ثمة قاسمًا مشتركًا بين الآراء المتنافرة يرجع نشأة الاعتزال ــ أو على الأقل تبلور بدايات أفكارهم ــ على وجه التقريب لزمن الحسن البصري. وعلى كل حال، كان للمعتزلة شأن غيرهم من الفرق سرديتهم التاريخية الخاصة، التي وقفت موقفًا وسطًا بين السرديتين السنية والشيعية.
الجاحظ
من المؤكد أن الجاحظ أشهر من أن يُعرَّف به، لكن نذكر نبذة لطبيعة المقال. وُلد في البصرة حوالي سنة ١٦٠ هـ، وفقًا لشارل بيلا، وتتلمذ على يد الجيل الثاني من رجال المعتزلة مثل إبراهيم النَّظَّام، وعلى يد غيرهم. ويذكر الغانمي في كتابه «معمار الفكر المعتزلي» أن هناك ما يشير إلى تلمذته على القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. وتتفق معظم المصادر على أن الجاحظ تُوفي سنة ٢٥٥ هـ.
وعلى الرغم من أن الجاحظ لم يقصد أن يكون مؤرخًا، إلا أن حِسًّا تاريخيًا يظهر في مؤلفاته، ومنها رسائل: العثمانية، النابتة، استحقاق الإمامة، وغيرها.
يمثل كتاب «العثمانية» للجاحظ نموذجًا للقراءة التاريخية الاعتزالية لتاريخ صدر الإسلام؛ فالجاحظ أراد أن يجعل من نفسه حكمًا بين أنصار عثمان وأنصار علي، أو إن شئت الدقة أراد الرد على الشيعة، لكنه لم يكن مجرد رجل يعرض مقالات الفرق، وإنما صاحب رأي ورؤية تاريخية. ومن اللافت للنظر أن هناك من رد على الجاحظ من المعتزلة كذلك، وهو أبو جعفر الإسكافي، لأنه شعر أن الجاحظ يتحامل على الإمام علي.
طُبع كتاب «العثمانية» عدة مرات قديمًا وحديثًا، غير أن أفضل الطبعات هي طبعة الأستاذ عبد السلام هارون الصادرة عن دار الجيل ببيروت. وهناك طبعة سعودية حديثة بعنوان جمل جوابات العثمانية، يذكر محققها أنه استدرك على الأستاذ عبد السلام هارون، غير أنها طبعة لا تخلو من محاولة التوجيه العقدي للقارئ.
القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي
أحد أشهر رجال المعتزلة ومن كبار منظريهم. وتشير المصادر إلى ولادته قبل سنة ٣٢٠ هـ، ويُعرف في الكتابات الاعتزالية والأصولية اللاحقة بقاضي القضاة. وترك العديد من المؤلفات مثل: فضل الاعتزال، تنزيه القرآن عن المطاعن، المغني في أبواب العدل والتوحيد، ولم يصلنا كاملًا وإن وصل معظمه. وما يهمنا هنا هو القسم الأخير من الكتاب المتعلق بمسألة الإمامة.
وفق تقسيم الناشر نجد جزأين مخصَّصين لمسألة الإمامة. وعلى الرغم من الطابع الجدالي لأبواب الكتاب بما يتناسب مع طبيعة التصنيف في علم الكلام، وكون المؤلف أفرد قسمًا منه للرد على الفرق الإسلامية في تلك المسألة، إلا أن الكتاب تضمن قراءة تاريخية لفترة الخلفاء الأربعة وحكم معاوية بن أبي سفيان، وإن لم تخلُ تلك القراءة من صبغة مذهبية اعتزالية واضحة؛ يفضل فيها المؤلف الإمام علي مع اعترافه بصحة خلافة سابقيه.
للكتاب طبعتان مشهورتان:
طبعة مصرية أشرف على تحقيقها طه حسين، وحقق الجزء المتعلق بالإمامة الدكتور محمود قاسم، وراجعها الأستاذ إبراهيم مدكور.
والمشهورة الثانية طبعة لبنانية صادرة عن دار الكتب العلمية لا تختلف عن الطبعة المصرية إلا في بعض الهوامش؛ فهي تصويرٌ لها تقريبًا.
ابن أبي الحديد المعتزلي
وُلد في المدائن لأسرة مشتغلة بالعلم سنة ٥٨٦ هـ، وتتلمذ على مجموعة من علماء عصره. وعلى الرغم من ميلاده لأسرة سنية المذهب، فإنه اختار الاعتزال كما يظهر من كتابه الأشهر «شرح نهج البلاغة»، الذي أهداه لراعيه الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي، في جو من الحرية والاستقلالية الفكرية يلفت النظر.
تقلّب في الوظائف الديوانية حتى عاصر سقوط بغداد على يد المغول وتُوفي بعد ذلك. والرجل الذي أراد شرح خطب الإمام علي ترك لنا محتوى تاريخيًا ضخمًا في ثنايا شرحه، ويعد صاحبُ هذه السطور رسالةَ ماجستير حول هذا الموضوع.
عادة ما يثير اسم «نهج البلاغة» جدلًا حول صحة نسبة نصوصه التي جمعها الشريف الرضي، وهل كل ما فيه يثبت عن الإمام علي أم بعضه، لكن عند الحديث عن «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد يمكن القول إن مسألة النسبة تصبح ثانوية؛ فالشرح الضخم الذي بلغ عشرين جزءًا يستحق الاهتمام؛ فالرجل موسوعي، واحتوى كتابه على التاريخ والكلام واللغة والأدب، فلم يكن مجرد شرح بسيط.
تمثل النصوص التاريخية عند ابن أبي الحديد حوالي نصف الكتاب تقريبًا، والرجل يقدم رؤية تاريخية منذ البعثة وحتى الغزو المغولي الثاني للشرق الإسلامي في عهد هولاكو، واحتلت نصوص صدر الإسلام القسم الأكبر. كشأن معتزلة بغداد يفضل ابن أبي الحديد الإمام علي على سائر الصحابة، مع قوله بصحة خلافة الثلاثة قبله. وفي الوقت نفسه لم تكن رؤيته قائمة على المناقب والفضائل وإن أقرّها، بل كانت رؤية عقلانية ومنطقية قائمة على استقراء الأحداث والروايات.
للكتاب طبعات عدة، لكن تظل أفضل طبعاته هي الطبعة المصرية التي صدرت في الستينيات بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن دار الحلبي، وعنها صُوِّرت معظم الطبعات. وأما الفهارس فقد نُشرت في طبعة دار الجيل اللبنانية، وهي تصوير للطبعة المصرية.